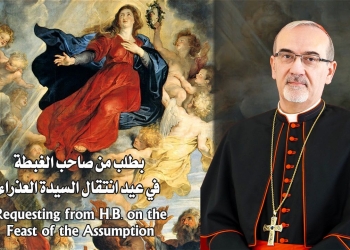المقدمة
أشكركم على دعوتكم، إنه لشرف لي. إنني ممتن لجامعتكم الموقرة التي تعاونت معنا لسنوات عديدة باعتمادها تخصص اللاهوت في المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية. أعتبر هذا الرابط بين روما والقدس ذا أهمية أساسية للكنيسة اليوم. كما أود أن أتوجَّه بأطيب تمنياتي لرئيس الجامعة الجديد، سيادة المطران أمارانتي، ونائب رئيس الجامعة الجديد، المطران فيري، وعميد كلية اللاهوت الجديد، المطران لاميري.
إن ما يحدث في الأرض المقدسة مأساة غير مسبوقة. فبالإضافة إلى خطورة السياق العسكري والسياسي الذي يزداد تدهورًا، فإن السياق الديني والاجتماعي يشهد تدهورًا كذلك. فالانقسامات بين الجماعات آخذة في التفاقم، والسياقات القليلة ولكن المهمة للتعايش الديني والمدني تتفكك تدريجيًا، مع حالة من عدم الثقة التي تتزايد يومًا تلو الآخر. إنه مشهد قاتم. ومع أنه لا شك في أن الأمل لا يزال قائمًا بين العديد من الناس الذين يواصلون السعي من أجل المصالحة والسلام رغم كل شيء، يجب أن نعترف بواقعية أن هذه الجهود محدودة وأن الوضع العام لا يزال مقلقًا للغاية.
لم تعزز هذه المأساة صلتي بالقطيع الذي أرعاه فحسب، بل أثارت أيضًا تأملات لا حصر لها حول السلام. ففي يومنا هذا، هل من الممكن حتى تصور "السلام" في الأرض المقدسة؟ يبدو مصطلح "السلام" مفهومًا بعيدًا وخياليًا خاليًا من المضمون، إن لم يكن موضوعًا يتم استغلاله إلى ما لا نهاية. ففي كثير من الأحيان، ينهي ذات الأشخاص الذين يؤيدون السلام خطاباتهم بالقول أنه لا مفر من الحرب لتحقيقه.
لا تزال أرضنا تنزف، ولا يزال شعبنا يقبع في قبضة الخوف وعدم اليقين من المستقبل. فكثيرون هم الذين ليس أمامهم سوى الركام.
إن الموضوع الذي اقترحتموه علي لهذه المحاضرة – خصائص ومعايير العمل الرعوي للسلام – لا يمكن تقديمه هنا إلا بإيجاز، دون تغطية شاملة. إن مهمتي هنا، كما أفهمها، لا تتمثل في إلقاء خطاب واقتراح معايير عامة لبناء سياقات السلام، أو مسارات ملموسة لسلام محتمل. إن المسارات والمعايير كما نعلم كثيرة: فإلى جانب المسارات الدينية، ثمّة مسارات اقتصادية وسياسية واجتماعية وإعلامية وتعليمية. وجميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الذاكرة والهوية والعديد من المفاهيم الأخرى. وهذا يعني أنه موضوع واسع جدًا. لن يكون هذا هو نطاق ما سأتطرق إليه، بل سأقدم لمحة تمهيدية مستمدة من خبراتي كراعٍ في الأرض المقدسة. انطلاقا من خبرتي الخاصة، سأحاول أن أشير إلى بعض المعايير التي ينبغي أن تستند إليها كنيسة الأرض المقدسة في سعيها لتحقيق السلام في هذا السياق المحدد، الذي أصبح اليوم محط اهتمام في جميع أنحاء العالم، ومصدر انقسام في العديد من المناطق الأخرى.
-
النظر إلى وجه الله
أولا، أعتقد أنه من المهم توضيح لماذا السلام هو موضوع مركزي لحياة الكنيسة وأعمالها في العالم.
الخاصية الأساسية للسلام هي أنه في الأساس عطية من الله، وليس مجرد مسعى بشري يتوافق مع الإرادة الإلهية. في الواقع، إنه يعكس شيئًا عن الله: أدوناي شالوم، أي "الرَّبُّ سَلام" (القُضاة 6: 24؛ راجعوا كومبنديوم عقيدة الكنيسة الاجتماعية، رقم 488). وكما هو معروف، فإن كلمة "شالوم" في العبرية والتي تعني "سلام" في اللغة العربية تتجاوز مجرد الدلالة على غياب الحرب في سياق اجتماعي سياسي: فهي تعبر عن "ملء الحياة" الذي هو بمثابة نهج متكامل. لذلك، فالسلام ليس مجرّد نتيجة المسعى أو التعايش البشريّ، بل هو حقيقة إلهيّة نابعة من العلاقة مع الله: إنه تحقيق للوعود المسيانية (أَشَعْيا 2: 2- 5؛ 11: 6- 9). يسوع المسيح هو سار شالوم، "رَئيسَ السَّلام" (أش 9، 5)، إنه "سَلامُنا" (أفسُس 2: 14)، الذي هدم الحاجز بين البشر، أي جدار العداوة الذي كان بينهما (أفسُس 2: 14- 16).
من القدس دوت صرخة القائم من بين الأموات التي وصلت إلى أقاصي الأرض: "السَّلامُ علَيكم!" (يوحنا 20: 19). ليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه أول كلمة من القائم من بين الأموات للرسل والنساء المجتمعين في العلية. وكأفراد جدد وقائمين، يجب أن تكون هذه أيضًا كلمتنا الأولى والأخيرة. وكما يقول المسيح، إنه ليس "سلامًا دنيويًا" بل "سلامي" (يوحنا 14: 27). لذلك، يأتي "سلامنا" من "سلامه،" لأنه بذل ذاته من أجلنا، فهو مات وقام من أجلنا. يكمن جوهر السلام في سر المسيح الفصحي. فمن خلال هذا السر، يحقق المسيح، الذي هو السلام، المصالحة بين البشر والله، وكذلك بين الناس أنفسهم. لهذا السبب، يجب التأكيد بقوة اليوم، على أن كل عمل رعوي واجتماعي للكنيسة لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن التبشير (راجعوا كومبنديوم عقيدة الكنيسة الاجتماعية، رقم 493): إعلان الإنجيل هو إعلان "بِشارةِ السَّلام" (أفسس 6: 15)، ومن يبشر يعلن السلام حتى لأعدائه، تماما كما فعل بطرس مع قُرنيليوس، الذي كان - ويجب ألا ننسى هذا أبدا في هذه الأوقات! - قائد المائةِ للقوات العسكرية التي كانت تحتل أرضه (أعمال الرسل 10: 36).
هذه الخاصية الأولى واللاهوتية العميقة للسلام تُقدم لنا المعيار الأساسي لتحقيقه ألا وهو النظر إلى وجه الله. وقد أشار القديس بولس السادس إلى هذا المعيار عندما حثّ الناس خلال اختتام المجمع الفاتيكاني الثاني على السعي إلى السلام. وليس بمحض الصدفة أن اليوم الذي وجّه فيه القديس بولس السادس هذه الدعوة أمام ممثلي 116 دولة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 4 تشرين الأول 1965 قد صادف يوم عيد القديس فرنسيس الأسيزي. وتكمن أهمية هذا الخطاب في حقيقة أنه لم يسبق لأي بابا في التاريخ أن ألقى شخصيًا خطاب سلام أمام الممثلين الدبلوماسيين لأعلى مجلس في العالم.
وفي نهاية خطابه، دعا البابا، بروح نبوية عظيمة، الأمم إلى ترسيخ السلام في الإيمان والتوجه نحو إلى الله: "إن الصرح الذي تقومون ببنائه لا يرتكز على أسس مادية وأرضية، لأنه في هذه الحالة سيكون بيتًا مبنيًا على الرمال. بل يعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الضمير. نعم، لقد حان الوقت "للإهتداء"، للتغيير الذاتي، للتجديد الداخلي …إن الخطر الحقيقي ينبع من الإنسان بحد ذاته، الذي لديه تحت تصرفه أدوات أقوى من أي وقت مضى، وهي مهيأة لإحداث الخراب بقدر ما هي مهيأة لتحقيق الفتوحات السامية. وباختصار، يجب أن يبنى صرح الحضارة الحديثة على المبادئ الروحية، لأنها وحدها القادرة ليس فقط على دعمها، بل أيضًا على إنارتها وإلهامها. ونحن مقتنعون، كما تعلمون، بأن هذه المبادئ التي لا غنى عنها للحكمة العميقة. لا تجد مرساها سوى في الإيمان بالله."
وهذا يعني أمرين متلازمين دائمًا: إدراك المرء لضعفه ورؤية وجه الله. هناك مقطع في سفر التكوين أحب أن أذكره دائمًا لأنه يوضح كيف يمكن التعرف على وجه الله. إذ يشير المقطع إلى القصة المعروفة عن مصارعة يعقوب لشخصية غامضة على ضفاف نهر يَبُّوق أثناء رحلته للقاء أخيه عيسو الذي كان على وشك أن يحاسبه. وفي هذا الصراع الفريد، يتعرّف يعقوب على وجه الله، فسمّى مكان الصراع "فَنوئيلَ،" أي "وجه الله". وعلى الرغم من خروجه من تلك الليلة المضطربة وهو يعرج، إلا أنه اعترف قائلاً: "إِنِّي رأَيتُ اللهَ وَجْهاً إِلى وَجْه" (سفر التكوين 32: 31). يخرج مهزومًا ولكن منتصرًا، يعرج ولكن متكلاً على الله. فقط عندما بات يعقوب يعرج استطاع أن يذهب للقاء أخيه العدو: فعانقه عيسو وبكيا. وعند هذه اللحظة، يخاطب يعقوب عيسو بواحدة من أجمل العبارات في الكتاب المقدس، والتي أحيانًا ما تُترجم بشكل غير دقيق، ولذلك أقدمها بصيغتها الحرفية: "فإِنِّيِ رَأَيتُ وَجهَكَ كما يُرى وَجهُ الله" (سفر التكوين 33: 10). فقط عندما نكون قد اختبرنا ضعفنا وواجهنا وجه الله من خلاله، نكون مستعدين للقاء الأخ العدو. إذا لم نذهب للقاء الآخر ونحن نعرج، فإننا نخاطر باستمرار بفتح سيناريوهات الحرب، لأن الآخر لم يعد أخًا لنا، بل عدوًا يجب الخوف منه أو القضاء عليه.
لكن في الكتاب المقدس يوجد أيضا منظور معاكس وتصادمي. وبالفعل، يصف سفر النبي عوبديا الجانب المظلم من تلك العلاقة، إذ يعلن لأدوم، وهو من سلالة عيسو، أنه "بِسَبَبِ قَتلِكَ وعُنفِكَ لِأَخِيكَ يَعْقوب سيَغْشاكَ العارُ وتَنقَرِضُ لِلأبَد." (سِفْرُ عوبديا 10). ومن هنا جاءت عظة النبي التي لا تزال ذات صلة اليوم كما كانت دائمًا: "فلا تَشمَتْ بِيَومِ أَخيكَ، بِيَومِ مُصيبَتِه" (سِفْرُ عوبديا 12).
-
النظر إلى وجه الآخر
ما أكدناه للتو يقودنا إلى الخاصية الثانية للسلام. فإضافة إلى كونه حقيقة إلهية، فهو أيضًا حقيقة إنسانية واجتماعية، وقيمة عالمية، وواجب حتمي يتطلب جهدًا من الجميع، لئلا تواجه البشرية الدمار الذاتي. ومع ذلك، فإن السلام، على المستوى الأنثروبولوجي، يتجاوز كونه مجرد عرف اجتماعي أو هدنة. إنه ليس مجرد غياب الحرب، أو نتيجة لجهود دبلوماسية وتوازنات جيوسياسية عالمية أو محلية، والتي للأسف تشهد انهيارًا في الأرض المقدسة! بالتأكيد، بالنظر إلى الظروف الحالية، فإن تحقيق كل هذا سيمثل بالفعل إنجازًا بارزًا! ومع ذلك، إن السلام ينطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فهو متجذّر في حقيقة الإنسانية، والتي هي الأساس الوحيد للطمأنينة الحقيقية للنظام (راجعوا القديس أغسطينوس، مدينة الله XIX، 13، 1)، وذلك لأن السلام مؤسس على مبادئ العدالة والإحسان.
وهنا إذا المعيار الثاني: إعادة الإنسان إلى المحور، والنظر إلى وجه الآخر، والاعتراف بالقيمة والكرامة الجوهرية لكل فرد. فعندما يتلاشى وجه الآخر، يتلاشى وجه الله وبالتالي نفقد السلام الحقيقي. فقط في سياق التنمية البشرية المتكاملة، مع احترام حقوق الإنسان، يمكن أن تولد ثقافة سلام حقيقية وظهور "الأنبياء العزل، الذين غالبا ما يكونون موضع سخرية" (كومبنديوم عقيدة الكنيسة الاجتماعية، رقم 496)، والذين هم بمثابة شهود وأعمدة للسلام. إن العالم بحاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى، حتى لو كان ذلك على حساب تعرضهم للاضطهاد ووصفهم بأنهم مثاليون وأصحاب رؤى. ومن أجل السلام، يجب على المرء أن يخاطر دائمًا وأن يكون على استعداد للتضحية بكرامته، وأن يموت مثل يسوع.
قال الفيلسوف اليهودي إيمانويل ليفيناس، "في اللقاء البسيط بين الإنسان والآخر، يكون الجوهري والمطلق على المحك. وعندما ألتقي بشخص آخر، أعيش تجربة تجلٍّ، فأدرك أن العالم هو ملكي بقدر ما يمكنني مشاركته مع الآخر. ويتجلى المطلق في القرب، على مرأى مني، ومن خلال إيماءة التواطؤ أو العدوان، الترحيب أو الرفض." (The Epiphany of the Face, cited in C. Pintus, “Including to communicate,” in E. Cauda - L. Scursatone [ed.], Education, communication, and Italian sign language, Varazze 2017, 14). لا أحد يعيش في العزلة: إذ عندما نسحق وجه الآخر، فإننا ندمر وجهنا نحن أيضًا، ولا سيما في زمن الترابط العالمي الذي نعيش فيه. إذا غرقنا، فسنغرق معًا، في ذات القارب، لأننا أصبحنا نعيش في قرية عالمية أكثر من أي وقت مضى.
-
رسالة الكنيسة
بعد هذه النظرة الموجزة على الجوانب اللاهوتية والإنسانية للسلام، دعونا الآن نتعمق في الموضوع الذي طرحتموه بشكل مباشر أكثر. نحن بحاجة إلى النظر في كيفية انعكاس هذا البعد في حياة الكنيسة، وكيف أن الكنيسة مدعوة لإيصال هذه الرسالة. وكما قلت في البداية، سأقتصر هنا فقط على رسم فكرة عن كنيسة القدس، بناءً على خبرتي الشخصية.
منذ فترة طويلة وكنيستنا تتأمل بعمق في هذا السياق الذي مزقته الحرب. وهو تأمل بنّاء يبقى حقيقيًا وراسخًا، يبتعد كل البعد عن الشعارات المبتذلة والعبارات الفارغة. يتعلق النزاع وتداعياته بحياة الجميع في أبرشيتنا، وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من حياة الكنيسة، وعنايتها الرعوية. كل ما نحن عليه وما نفعله له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالنزاع وعواقبه، إن كان ذلك يتعلق بالجوانب العملية أو بالتفكير العميق في القضايا الأكثر تعقيدًا: كالحدود المغلقة وإصدار تصاريح العبور أو رفضها، والرد المسيحي المحتمل بشأن الاحتلال. ما أعنيه هو أن النزاع ليس قضية مؤقتة وثانوية في حياة كنيستنا، بل هو الآن جزء لا يتجزأ من هويتنا ككنيسة: فالنزاع والانقسام، مع ما يترتب عليهما من كراهية واستياء، يشكلان واقعًا معتادًا علينا التعامل معه، ويملي على الجماعة المسيحية أن تنخرط في التأمل المتواصل، وأن تطور استراتيجيات روحية ورعوية واجتماعية. لذلك، فالحديث عن السلام، بالنسبة لنا، ليس حديثًا عن موضوع مجرّد، بل عن جرح عميق في حياة الجماعة المسيحية، يسبب المعاناة والإرهاق، ويمس حياتنا البشرية والروحية بعمق.
لا أعلم ما إذا كنا قد تمكنا من التوصل إلى خلاصة في تفسير هذا الموضوع، على الأرجح ليس بعد. وأعتقد أن تفكيرنا حول السلام سيظل دائمًا موضع تأمل مستمر، ولن نتمكن أبدًا من التوصل إلى خطاب قاطع تمامًا، ولكن سيتعين علينا التعامل مع التطورات المستمرة للإطارات السياسية المختلفة التي تتشكل وتتفكك من وقت لآخر، وعواقبها على حياة شعوب الأرض المقدسة. فمثل هذه الأوضاع تتحدى إيماننا باستمرار. وربما هذا ليس وقت التلخيص بل للإصغاء - لمختلف الأصوات والمشاعر ووجهات النظر والصراعات والآمال، ومحاولة فهمها في ضوء الإنجيل، مع السعي إلى تحديد بعض السمات المشتركة، وبعض الخصائص والمعايير التي يجب أن ترافق تأملنا على الدوام.
في الواقع، لا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا كيف نعيش السلام في القدس، المدينة المدعوة لتكون راعية السلام، ولكنها مبتلاة بالصراع الدائم.
بالنسبة لنا، إن كنيسة الأرض المقدسة، التي تقع في سياق مجتمع متعدد الأديان والثقافات، غني بالتنوع ولكن أيضا بالانقسامات، فإن "سلام القدس" الذي يتحدث عنه مزمور 121، لا يعني زوال الاختلافات أو ردم المسافات. كما أنه ليس مجرد هدنة أو ميثاق عدم اعتداء تضمنه المعاهدات والجدران. بدلاً من ذلك، نحن مقتنعون بأن السلام متجذر في القبول الودي والصادق للآخرين، والالتزام الثابت بالحوار والإصغاء. كما أننا على قناعة بأن جماعتنا مدعوّة لأن تكون طريقًا مفتوحًا حيث تحل المعرفة والثقة محل الخوف والشك. وهنا، يُنظر إلى الاختلافات على أنها فرص للشراكة والتعاون بدلاً من أن تشكل دوافع للحرب.
سيتعين علينا أن نحول تركيزنا على نحو متزايد من التركيز على احتلال الهياكل المادية والمؤسسية إلى تعزيز ديناميكيات الحياة الإيجابية والجميلة، والتي يمكننا كمؤمنين أن نبادر بها. وقد نشعر أحيانًا بإغراء الهروب أو الاستسلام، أو الخضوع بسهولة للسلطة، أو اللجوء إلى العنف كرد وحيد للأوقات الصعبة التي نواجهها.
تكمن أهميتنا كمؤمنين ومتدينين في مدى توافق أفعالنا اليومية مع إيماننا. ففي سياق اجتماعي وسياسي تهيمن عليه مشاعر القهر والعزلة والعنف، نتمسك بثبات بمبادئ اللقاء والاحترام المتبادل كالطريق الوحيد نحو تحقيق السلام.
وفي حين أن السلام يتطلب أفعالاً حاسمة وجريئة من جميع المؤمنين، إلا أنه يتطلب أيضًا إعلانه والدفاع عنه بالكلمات المنطوقة.
لهذا السبب، غالبا ما نجد أنفسنا عند مفترق طرق، حيث يجب علينا أن نختار بين ضرورة إدانة العنف وسوء المعاملة، وخاصة التي تُرتكب ضد الفئات الأكثر ضعفًا، وبين خطر اختزال الدين إلى مجرد "أداة سياسية" أو الانحياز إلى أحزاب أو فصائل معينة، وبالتالي التخلي عن جوهره الحقيقي وجعله عرضة للاستغلال السهل والسطحي.
إن وجودنا في الأرض المقدسة كمؤمنين يجب أن يتجاوز مجرد التأمل الروحي والأعمال الخيرية. إنه يستلزم أيضًا التزامًا جماعيًا، متجذرًا في خبراتنا الدينية المتنوعة، بالانخراط في العالم وديناميكياته وتقييمها (يوحنا 16: 8، 11). نحن نعلم جيدًا كيف تغلف السياسة الحياة العادية من جميع جوانبها في الشرق الأوسط. كل شيء يتحول إلى سياسة، وهذا ما يطرح سؤالاً جديًا على جميع مؤسساتنا الدينية وعلى المؤمنين الذين ينتظرون منا كلمة رجاء وتعزية ولكن أيضًا كلمة حق. إن ما نحتاجه في هذه الحالة هو عملية تمييز صعبة ومستمرة لم تتحقق بشكل قاطع من قبل. إنها تنطوي على القدرة على الإصغاء إلى جميع وجهات النظر وتفسير الحاضر بشكل نقدي ونبوي.
لا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه الظلم أو أن نعيش حياة العزلة وعدم الاكتراث. ومع ذلك، فإن إعطاء الأولوية لاحتياجات الفقراء والضعفاء لا يجعلنا ننحاز إلى أي حزب سياسي معين. فبينما يتم حثنا في كثير من الأحيان على اتخاذ موقف، لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى المواجهة، بل يجب أن يتجلى في أفعال وأقوال ملموسة نيابة عن أولئك الذين يعانون. لا ينبغي أن تكون استجابتنا مجرد شعارات أو إدانة ضد الآخرين. قد يكون من المغري أن ننضم إلى جوقة النقد واللوم وكسب التصفيق والتأييد، لكن هذا قد يكون إغراءً دنيويًا. باختصار، نحن مدعوون كمؤمنين أن نحب ونخدم المجتمع وندافع عن الخير العام، وخاصة الفقراء والمهمشين، دون أن ننشغل بالمنافسة أو الانقسام. نحن مدعوون لرفع أصواتنا للدفاع عن حقوق الله وحقوق الإنسان مع الحفاظ على الوحدة والتضامن.
وبالنظر إلى هذه المقدمات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نعيش هذا؟ ما هي الخصائص والمعايير الضرورية؟ ما الذي يشكل أساس نهجنا وطريقة عيشنا كمسيحيين وككنيسة في الأرض المقدسة؟ ما هي العناصر التي يجب أن توجه باستمرار تفكيرنا المسيحي حول السلام، وما هي المبادئ التي يجب أن توجه فهمنا للوضع الحالي؟ ما هي المجالات التي يجب التركيز عليها لتأسيس نهج رعوي كنسي قوي وذو مصداقية تجاه السلام؟ وبطبيعة الحال، ثمة جوانب عديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي تتطور باستمرار، كما ذكرت سابقًا. إن الخدمة الرعوية للسلام، مثلها مثل أي مسعى رعوي آخر، تتطلب أفرادًا ملتزمين، ومنهجية محددة، ومبادئ روحية واضحة تدعم أعمالها وأهدافها.
3.1 القيادة
في السياق المبين أعلاه، فإن دور القيادة الدينية، لا سيما في الشرق الأوسط، أمر بالغ الأهمية. أولاً، هناك حاجة إلى المرشدين والكهنة والقادة القادرين على الإصغاء إلى مجتمعهم وأن يكونوا صوتًا له وأن يقدموا التوجيه والإرشاد.
فبدلاً من الوقوف مع الأنظمة السياسية التي تفتقر إلى المصداقية، ينبغي على القادة الدينيين إعطاء الأولوية للتعاون مع أكثر شرائح المجتمع أخلاقية لتعزيز ثقافة جديدة من الشرعية. وعليهم أن يسعوا إلى أن يكونوا صوتًا للعدالة وحقوق الإنسان والسلام بعيدًا عن التأثيرات الخارجية وأن يكونوا نبويين في دعوتهم. وكما ذكرنا في البداية، فإن هذه القيم ليست قيمًا إنسانية فقط، بل هي في المقام الأول انعكاس لتطلعات الله للبشرية. وعند مواجهة التحديات المحلية الهائلة، فإن مساهمة القيادة الدينية في الصمود والابتكار لا تكمن في إعادة اختراع العجلة باستراتيجيات عملياتية جديدة بل في أن تكون شاهدًا لله بصدق وإخلاص واندفاع.
أتساءل عما إذا كنت في أفعالي وأقوالي أخاف الله أكثر أم أخاف من ردود أفعال الناس والسياسيين ووسائل الإعلام… عند مخاطبة مجتمعي، هل أتحلى بالشجاعة للتحدث بصراحة، ولتقديم الإرشاد والتوجيه؟ هل أفتح آفاقًا جديدة؟ أم أقتصر ببساطة على اختيار كلماتي بحرص لتجنب إزعاج الآخرين؟
هذه ليست بمسألة بسيطة، بل هي مسألة محورية. وفي أوقات الألم والضياع، وفي إطار مجتمعي يحظى فيه الدين بمكانة بارزة، فمن الضروري أن نتساءل باستمرار كيف يمكن للإيمان أن يوجه المجتمع دون السماح له بالخمود. يجب أن يمنح الإيمان الراحة والعون، ولكن يجب أن يكون أيضًا مقلقًا إلى حد ما. إذا كان الإيمان متجذرًا في تجربة متسامية، فينبغي أن يدفعنا إلى تجاوز اللحظة الراهنة، وتوسيع مداركنا وقلوبنا، وتجاوز الحدود.
في سفر التثنية (30:15)، يقول الله، "انظُرْ! إِنِّي قد جَعَلتُ اليَومَ أَمامَكَ الحَياةَ والخَير، والمَوتَ والشَّرّ." من الضروري أن ندرك أن المرء قد لا يختار لا الحياة ولا الخير، وهو واقع واضح في الحياة اليومية. ومع ذلك، يجب علينا أيضًا أن نفكر في كيفية مواجهة أولئك الذين يختارون الشر والموت والتفكير في الموقف المناسب للمؤمن في مثل هذه الظروف. كيف ينبغي على القادة الدينيين أن يتصرفوا في هذه السيناريوهات المحددة؟ ما هي الإرشادات التي يجب أن يقدموها لمجتمعاتهم ليس فقط فيما يتعلق بالشر المجرد، بل فيما يتعلق بمن يرتكبونه؟ كيف يمكننا تفسير هذه المواقف بموضوعية في ضوء كلمة الله؟
وسواء اعترفنا بذلك أم لا، لطالما كان الدين والسياسة متشابكين بشكل وثيق على المستوى الاجتماعي. ففي الشرق الأوسط، يقوم الإيمان والدين بمهام متكاملة داخل المجتمعات الوطنية، مما يؤدي حتمًا إلى تفاعل السياسة مع الدين ودوره العام.
وقد تصارع كل جيل في تحديد معايير وأساليب إدارة العلاقة بين هذين المجالين في النسيج الاجتماعي لبلدانهم. ويواجه جيلنا والجيل الذي يليه تحديات فريدة من نوعها، إذ لا يتعلق الأمر فقط بتحديد التفاعل بين السياسة والدين، بل بإعادة النظر في دور كل منهما على حدة، بصرف النظر عن الترابط بينهما. وفي كثير من الأحيان، تجد السياسة الوطنية والدين نفسيهما في نفس القارب، حيث يتم تحميلهما مسؤولية المشاكل المعاصرة مثل الشرور والرجعية وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الإيمان الديني دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل مفاهيم مثل التاريخ والذكريات والذنب والعدالة والغفران، مما يجعل المجال الديني في تفاعل مباشر مع المجالات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية.
ويتطلب التغلب على الصراعات بين الثقافات إعادة النظر في التفسيرات المتنوعة والمتضاربة للروايات الدينية والثقافية والتاريخية والتوفيق بينها. فالجروح التي حدثت في الماضي البعيد والقريب، بمجرد الاعتراف بها ومعالجتها ومشاركتها، قد تستمر في إحداث الألم لسنوات، بل ولقرون. في هذا الصدد، أكد البابا فرنسيس ما يلي:
هناك حاجة، في أجزاء كثيرة من العالم، إلى مسارات سلام تقود إلى التئام الجروح، وهناك حاجة إلى صانعي سلام، مستعدّين للشروع في عمليّات الشفاء والتلاقي، ببراعة وجرأة. إن التلاقي لا يعني العودة إلى ما قبل الصراعات. فقد تغيّرنا جميعًا بمرور الوقت، لقد غيَّرَنا الألم والمواجهات. وكذلك، لم يعد هناك مكان للدبلوماسيّة الفارغة، والتمويه، والخِطَب المزدوجة، والتستّر، ولا للسلوكيّات الحسنة ظاهريًّا التي تخفي الواقع. فالذين تواجَهوا بقوّة فيما بينهم يتحدّثون انطلاقًا من الحقيقة، الواضحة والمجرّدة. عليهم أن يتعلّموا كيف ينمّون ذاكرة تساعدهم على التوبة، قادرة على تحمّل مسؤولية الماضي كي يحرّروا المستقبلَ من أيّ استياء، أو ارتباك، أو نظرة سلبية. فانطلاقًا من الحقيقة التاريخية للحقائق وحدها سيتمكّنون من بذل جهد مستمرّ وطويل في فهم بعضهم البعض ومحاولة وضع تركيب جديد لصالح الجميع. الحقيقة هي أن "عمليّة السلام هي التزام يدوم مع مرور الوقت. إنه عمل صبور من البحث عن الحقيقة والعدالة؛ عمل يكرّم ذكرى الضحايا ويفتح، خطوة بعد خطوة، على رجاء مشترك، أقوى من الانتقام.
لا يمكن السير في هذه المسارات بمفردنا. فالمجتمعات الوطنية، سواء كانت سياسية أو دينية، تتطلب أفرادًا قادرين على تعزيز وتوجيه وإرشاد نحو فهم أعمق للذات وللآخرين، وأحيانًا حتى على حساب تحمل الوحدة وسوء الفهم والرفض.
من المؤكد أن مسؤولية السلام لا تقع على عاتق الكهنة أو القادة الدينيين وحدهم. لا أريد أن أعطي انطباعًا بأن القادة وحدهم يصنعون السلام. ومع ذلك، فهم مكلفون بإرشاد مجتمعاتهم ومرافقتهم والإصغاء إليهم، وخلق بيئات يمكن للمجتمعات أن تعبر عن نفسها. وفي حين أن الكاهن وحده لا يشكّل الجماعة، إلا أن الجماعة تعتمد اعتمادًا كاملا عليه. ومن خلال الحوار المتواصل، والإصغاء المتبادل، والمشاركة، تنبثق خدمة رعوية هادفة للسلام. لذلك، لا غنى عن دور القادة والأنبياء وصوت الكهنة.
3.2 الحوار بين الأديان
كما قال الحاخام ج. أ. هيشيل بحكمة، لا يوجد دين منعزل. لذلك، لا يمكن للكنيسة أن تفترض أنها تتحمل مسؤولية تعزيز السلام وحدها. سيكون هناك الكثير من الافتراض في ذلك. وكأن العالم كله ينتظر رسالتنا ومثالنا. إنه ليس كذلك. على الأقل، ليس كذلك في الأرض المقدسة. وكما هو الحال في العالم بأسره الآن، نحن نعيش في سياق متعدد الثقافات والأديان. فمن دون تعاون الكنائس والطوائف الدينية الأخرى، لا يمكن أن يكون لأي خدمة سلام كنسية مضمون. إن الانخراط في مبادرات السلام التعاونية سيساهم أيضًا في إيجاد حلول للمشاكل التي تعتري مجتمعاتنا لأنه فقط من خلال العلاقات الصادقة مع الآخرين يمكننا أن نفهم أنفسنا بصدق.
إن الأديان المختلفة، في إطار حقيقتها ودعوتها العميقة، هي حاملة لموارد المصالحة وصنع السلام، ونادرا ما تكون هي المحرك الوحيد أو الرئيسي لسوء التفاهم والصراعات، كما أنها ليست في حد ذاتها عامل خطر في هذا الصدد. ولكن إذا ما أصبحت عاملاً وظيفيًا للصراع السياسي، كما هو الحال غالبًا في الأرض المقدسة، تصبح الأديان مثل الوقود الذي يُلقى على النار.
لقد أثمر الحوار بين الأديان عن وثائق ذات مغزى عميق تدعو إلى الأخوة الإنسانية، وتؤكد هويتنا المشتركة كأبناء الله، وتشدد على أهمية الجهود التعاونية لحماية الحقوق الفردية. هذه هي ثمار الجهد الذي أعتبره روحانيًا.
ولكن، في خضم السياق الحالي للحرب في الأرض المقدسة، يبدو أن هذه المبادئ قد باتت حبرًا على ورق.
هناك غياب ملحوظ في هذه الحرب: صوت القادة الدينيين. فباستثناءات قليلة، لم نسمع في الأشهر الأخيرة خطابات أو تأملات أو صلوات من القيادات الدينية، على عكس تلك التي تصدر عن القيادات السياسية أو الاجتماعية. ومع أنني آمل أن أكون على خطأ، إلا أنه يبدو أن الجميع يتحدثون حصريًا ضمن منظور مجتمعهم.
يبدو أن العلاقات بين الأديان التي كانت تبدو راسخة الآن قد تقوضت بسبب شعور مقلق بانعدام الثقة. يشعر كل من الطرفين بأن الآخر يخونه، ولا يفهمه، ولا يدافع عنه، ولا يدعمه.
لقد سألت نفسي عدة مرات في الأشهر الأخيرة عما إذا كان الإيمان بالله هو حقًا الأساس في تشكيل الضمير الشخصي، وبالتالي تعزيز الفهم المشترك بين المؤمنين، على الأقل في بعض الجوانب الرئيسية للحياة الاجتماعية، أم أن فكرنا يتشكل ويستند إلى شيء آخر.
لم تشعر الطائفة اليهودية بأنها مدعومة من قبل المسيحيين، وأعربوا عن ذلك بوضوح. والمسيحيون بدورهم، المنقسمون كالعادة في كل شيء، والعاجزون عن كلمة مشتركة، إما منقسمون في دعم هذا الطرف أو ذاك، أو غير متأكدين ومشوشين. أما المسلمون فقد شعروا بأنهم مستهدفون ومتّهمون بالتواطؤ في المجازر التي وقعت في 7 تشرين الأول ... خلاصة القول، بعد سنوات من الحوار بين الأديان، وجدنا أننا لا نفهم بعضنا البعض. لقد تسبب لي ذلك في حزن كبير، ولكنه كان أيضًا بمثابة درس عظيم.
ومن هذه التجربة، علينا أن نبدأ من جديد، مدركين أن للأديان أيضًا دورًا محوريًا في توجيه المجتمع. ولعل حوارنا يجب أن يخطو خطوة مهمة إلى الأمام، انطلاقًا من سوء فهمنا الحالي واختلافاتنا وجراحنا. ولا يمكن أن يظل حوارًا بين المنتمين إلى الثقافة الغربية فقط، كما كان حتى الآن، ولكن سيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار الحساسيات ووجهات النظر الثقافية المتنوعة، ليس فقط الأوروبية بل المحلية في المقام الأول. هذا النهج أكثر صعوبة، ولكن يجب أن نبدأ به.
تمثل هذه الحرب نقطة تحول في الحوار بين الأديان، لا سيما بين المسيحيين والمسلمين واليهود، حيث لن يكون الأمر كما كان عليه من قبل.
ويجب أن يتم ذلك ليس بدافع الحاجة أو الضرورة، بل بدافع المحبة. لأننا نحب بعضنا البعض على الرغم من اختلافاتنا، ونرغب في أن نرى هذا الخير يتجلى بشكل ملموس ليس فقط في حياتنا الخاصة ولكن أيضًا في مجتمعاتنا. إن محبة بعضنا البعض لا تعني بالضرورة أن يكون لدينا نفس الآراء، بل تستلزم القدرة على التعبير عن وجهات النظر المتنوعة وتقديرها، مع احترام وتقبل بعضنا البعض.
عندما يكون الحوار بين الأديان صادقًا ويتطرق إلى القضايا ذات الصلة بالمنطقة والمجتمعات المعنية، فإنه يعزز ثقافة التلاقي والاحترام المتبادل. ويخلق الخلفية الضرورية التي يمكن أن تستند إليها وجهات النظر السياسية اللاحقة.
3.3 المغفرة
بعد أن حددنا المسؤوليات التي لا غنى عنها للقيادة الدينية فيما يتعلق بالرعاية الرعوية للسلام والحاجة إلى نهج "منفتح" للعمل، علينا الآن أن نتساءل عن المهام التي ينبغي على القادة الدينيين التركيز عليها، سواء داخل مجتمعاتهم أو في الحوار مع بعضهم البعض. ما هي الأهداف التي يجب أن يسعوا إليها، وكيف ينبغي تحقيقها، وبأي أسلوب يجب أن تعيش مجتمعاتهم هذا البعد المركزي لإيمانها؟
تبرز المغفرة كموضوع رئيسي. لا يمكن مناقشة السلام بعبارات مجردة، كما لو كان مجرد فكرة. السلام ليس شيئا يجب على المرء القيام به، بل هو أسلوب للوجود في الحياة، وموقف متكامل للشخص والجماعة. وفي كل موقف - سواء كان شخصيًا أو جماعيًا - يجب أن نواجه الجراح التي تسببها الانقسامات والتملك والإقصاء والكراهية. في الأساس، يجب أن نواجه الخطيئة. وفي هذا السياق، يرتبط السلام ارتباطًا وثيقًا بالمغفرة. فهما ضروريان بشكل وثيق لبعضهما البعض، إن لم يكونا مترادفين.
يوحي لنا الكتاب المقدس أن المغفرة، تمامًا كالسلام، تنبع من محبة الله. إنه يقتضي مسيرة شخصية، وعملية فهم والتغلب على الشر الذي تم تلقيه أو ارتكابه. لن يحدث ذلك ما لم يتخذ الشخص إجراءً. لا يمكن نسيان الشر المرتكب، بل يتطلب إرادة للتغلب عليه، نابعة من رغبة واضحة وثابتة. إنه لا يمحو الإساءة المرتكبة بل يسعى إلى التغلب عليها من أجل خير أكبر. إن محاولة النسيان أو الاعتماد فقط على الوقت لتضميد الجراح، دون التغلب على الشر المرتكب والتعرف عليه، والنظر في وجهه، ومناداته باسمه، يعني جعل المغفرة بادرة مبتذلة، لا تشفي أي جرح، ولا تغير قلوب الناس، ولا تحقق السلام.
على المستوى الاجتماعي والسياسي، يستغرق التفكير في المغفرة وقتًا طويلا. وغالبًا ما تكون المسارات التي يجب اتباعها معقدة للغاية لأنها لا تقتضي مراعاة العلاقات الشخصية أو علاقة يحددها سياق ما، بل علاقة اجتماعية. أي أنه يجب على المرء أن يراعي جراح وآلام الجميع، والتفسيرات المختلفة للأحداث التي تسببت في الألم الجماعي.
للتطلع إلى المستقبل بأمل وصفاء، من الضروري الخضوع لعملية تنقية الذاكرة. فالجراح التي لم تلتئم تولد مشاعر الضحية والغضب، مما يعيق المصالحة وربما يجعلها مستحيلة. ستستمر الجراح الناجمة عن الماضي في تشكيل أعباء تُثقل كاهلنا وتؤثر على نظرتنا لعلاقاتنا مع الآخرين ما لم يكن هناك تنقية جماعية للذاكرة، واعتراف متبادل بالشر الذي ألحقه كل منا بالآخرين وتحمله، وإعادة تقييم لروابطنا التاريخية.
يعزز الإيمان بطبيعة الحال الشعور بالانفتاح لدى المؤمن لتكوين علاقات. تبدأ هذه العلاقة بلقاء مع الله، والذي بدوره يقدم للأفراد نظرة إلى الآخرين تنبع من داخلهم.
كما أنه ثمّة حاجة إلى التربية الإنسانية على الغفران، أي تنشئة ثقافية تمكّن الأفراد من النظر إلى الأحداث بمنظور لا يقتصر على جراحهم التي دائمًا ما يكون أفقها محدودًا ومغلقًا. سيساعد هذا في تفسير الأحداث على المستويين الشخصي والجماعي، مع وضع المستقبل في المنظور الذي يأخذ في الاعتبار أيضا خير الآخرين والواقع الاجتماعي والحاجة إلى إعادة تنشيط ديناميكيات الحياة. لذلك، في هذا السياق، يكون التفكير في الغفران مفتوحًا أيضا لغير المؤمنين.
إن الثمرة الأولى للغفران هي التحرر من الروابط العاطفية الناتجة عن الاستياء والانتقام، والتي بخلاف ذلك توقع الأفراد الذين يحاولون تكوين علاقات في دوامة من الألم والعنف. يسمح الغفران بشفاء روح الإنسان، ويعيد تنشيط ديناميكيات الحياة، ويبني المستقبل.
يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المجالات: السياسية والدينية والمدنية، في آن واحد، بحيث تشمل مختلف المجموعات التي تشكل الآراء والمعتقدات، كالمدارس والجامعات ووسائل الإعلام. وذلك لأن الناس يتفاعلون على جميع هذه المستويات. ولا يمكن للمغفرة، في دورها المتمثل في شفاء الأفراد، أن تكون فعالة إلا عندما تشرك كل جانب من جوانب كيان الفرد.
تضطلع الكنيسة، إلى جانب الجماعات الدينية الأخرى، بدور أساسي في تعليم المصالحة، وتهيئة بيئة مواتية للمغفرة، لكنها لا تستطيع فرضها. من الضروري منح الوقت والوقار لأولئك الذين يكابدون المعاناة، مع مساعدتهم أيضًا على إعادة قراءة تاريخهم، والسماح للجروح بالالتئام. في كثير من الأحيان في الأرض المقدسة، يتعلق الأمر بالتحلي بالصبر. إن قلوب الناس والجماعات ليست دائما مستعدة وحرة للتحدث عن المغفرة. فالألم لا يزال شديدًا جدًا. وغالبا ما يكون الغضب أسهل من الرغبة في المغفرة. لذلك من الضروري التحلي بالصبر، ولكن في الوقت نفسه ينبغي اقتراح باستمرار السبيل المسيحي لتحقيق السلام.
حتى الآن، فشلت جميع اتفاقيات السلام في الأرض المقدسة، لأنها كانت في كثير من الأحيان اتفاقات نظرية، افترضت حل سنوات من المأساة دون أن تأخذ بعين الاعتبار العبء الهائل من الجراح والألم والاستياء والغضب الذي لا يزال يشتعل وينفجر بطريقة عنيفة للغاية في الأشهر الأخيرة. كما أنه لم يؤخذ في الاعتبار السياق الثقافي وخاصة الديني، الذي كان يتحدث بلغة تتعارض مع دعاة السلام (بدءًا من القادة الدينيين المحليين).
لذلك، في هذا السياق، يجب على العناية الرعوية للكنيسة أن تُولي الأولوية لتعزيز المغفرة والمصالحة. هذا النهج يأخذ في الاعتبار الجراح والآلام، ولكنه لا يتوقف عند هذا الحد. في حين أن الألم يمكن أن يؤدي إلى العزلة الذاتية، إلا أنه قادر أيضًا على فتح أبعاد جديدة ويؤدي إلى التجديد. من دون هذا المنظور، لا يمكن لأي مبادرة سياسية أن تنجح في الأرض المقدسة، وسيبقى السلام مجرّد شعارًا يفتقر إلى المصداقية. وبالتالي، فإن مهمة الكنيسة الرعوية تستلزم اقتراح طرق المصالحة دون كلل، ومرافقة جهود الشفاء، واقتراح لغات لا تستثني أحدًا، ونسج شبكات العلاقات بصبر، وبناء الثقة داخل الجماعة الكنسية، ثم مع الجماعات الدينية الأخرى من خلال أعمال ملموسة.
3.4 الحقيقة والعدالة
كما ذكرت سابقًا، إن المغفرة موضوع مركزي لخدمة السلام. لكن في سياقنا هذا، لا يمكن فصل الغفران عن كلمتين أخريين: الحقيقة والعدالة.
إن المعاناة والألم والجراح التي سببها هذا النزاع معروفة جيدًا. لست هنا لأسرد الشرور التي يتم ارتكابها. فهذا ليس موضوع هذا الاجتماع، وأعتقد أنه موضوع معروف للجميع. كما أنني لا أنوي الخوض في مسألة هذه المرحلة من النزاع الدائر والذي اندلع في 7 تشرين الأول.
على مرّ العقود، شهدت الأراضي المقدسة احتلالًا إسرائيليًا لأراضي الضفة الغربية، مما أدى إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين وكذلك على الإسرائيليين. إن التداعيات الرئيسية والأكثر وضوحًا لهذا الوضع السياسي هو تفشي الظلم وعدم الاعتراف بالحقوق الأساسية، والمعاناة التي يكابدها السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية. إنها حالة موضوعية من الظلم.
كما قلت سابقًا، بالنسبة لكنيستنا، فإن الصراع مع عواقبه هو جزء لا يتجزأ من الحياة العادية، وهو حتمًا جزء من تفكير الجماعة بأسرها. وفي كثير من الأحيان، كما هو الحال الآن، يؤدي ذلك إلى تفكير ونقاش قاسي ومؤلم. إن الحفاظ على الشركة بين الكاثوليك الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا السياق الممزق والمستقطب، أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
لذلك، من غير الممكن مناقشة التسامح دون التطرق أيضًا إلى الحقيقة والعدالة. إن عدم قول كلمة حقيقة عن حياة فلسطيني، التي اتسمت بعقود من انتظار تحقيق العدالة والكرامة، سيكون بمثابة تبرير لحالة موضوعية من الظلم.
وبصفتي بطريرك القدس للاتين، وجدت نفسي، منذ بداية هذا النزاع، في موقف يتطلب خيارًا، وموقفًا واضحًا. كيف يمكنني التوفيق بين هذه الدعوة للانحياز وبين ما أنا عليه وما قلته للتو عن المغفرة؟ كيف أدافع عن حقوق الله والإنسان في هذا السياق، وكيف أتحدث عن المغفرة، وأكون مخلصًا للمسيح الذي يغفر بحرية على الصليب، دون إعطاء الانطباع بعدم الدفاع عن القطيع الموكول إلي، وحقوقه، وتوقعاته؟ كيف أُنادي بحب الأعداء دون إعطاء الانطباع بتأكيد رواية ضد أخرى عن غير قصد، إسرائيلية ضد فلسطينية، أو العكس؟ كيف يمكنني أن أرأب الانقسامات من خلال قرارات حازمة وعادلة، لكن دون أن أزيدها تفاقمًا، وأن أتصرف دائمًا برحمة؟
وبشكل أكثر تحديدًا، كثيرًا ما أُسأل: "كيف يمكنني التفكير في مسامحة الإسرائيلي الذي يضطهدني، طالما أنني تحت القمع؟ ألن يعني ذلك إعطائه السلطة، وإطلاق العنان له دون الدفاع عن حقوقي؟ قبل الحديث عن المغفرة، أليس من الضروري أن تتحقق العدالة؟" وقد يضيف الإسرائيلي بدوره: "كيف لي أن أسامح من يقتل شعبي؟" يقف وراء تلك الأسئلة ألم حقيقي وصادق يجب احترامه.
لا أعرف ما إذا كان من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة، لكن لا يمكن للمرء تجنب طرحها. لا يمكن لخدمة السلام أن تتجاهل جراح مجتمعها، ولا يمكنها خداعه بإجابات سهلة لا تمس الحياة الحقيقية. بعض الحالات ليس لها حلول فورية وربما لا توجد حلول على الإطلاق. ولكن مع ذلك هناك طريقة مسيحية للعيش في ظل النزاع. يمكن عيش السلام حتى في مثل هذه الظروف. وبدلًا من تقديم إجابات سهلة، غير موجودة على الأرجح، من الضروري المساعدة في تحديد المسارات وأنماط الحياة التي تفضي إلى السلام.
لقد حاولت أن أشير إلى بعضها، من خلال رسالة إلى الأبرشية أرسلتها قبل بضعة أشهر، وأود أن أقتبس منها هنا:
"إن التحلي بشجاعة المحبة والسلام هنا، اليوم، يعني عدم السماح للكراهية والانتقام والغضب والألم بأن تحتلّ كلّ مساحة قلوبنا، وخطاباتنا وتفكيرنا. إنه يعني أن نلزم أنفسنا شخصيا بالعدالة، وأن نكون قادرين على تأكيد وإدانة الحقيقة المؤلمة للظلم والشر التي تحيط بنا، ودون تلويث علاقاتنا ببعضنا. إنه يعني الالتزام والاقتناع بأنه لا يزال من المجدي بذل كل ما في وسعنا من أجل السلام والعدالة والمساواة والمصالحة. يجب ألا يمتلئ خطابنا بالموت والأبواب المغلقة. على العكس من ذلك، يجب أن تكون كلماتنا خلاقة، تعطي الحياة، وتخلق رؤية، وتفتح آفاقا.
يتطلب الأمر شجاعة لنكون قادرين على المطالبة بالعدالة دون نشر الكراهية. يتطلب الأمر شجاعة لطلب الرحمة، ورفض الظلم، وتعزيز المساواة دون فقدان الهوية، لا بل مع المحافظة على حريتنا. يتطلب الأمر شجاعة اليوم، أيضا في أبرشيتنا وفي جماعاتنا، للحفاظ على الوحدة، والشعور بالوحدة مع بعضنا البعض، على الرغم من تنوع آرائنا وحساسياتنا ووجهات نظرنا.
أريد ونريد أن نكون جزءا من هذا النظام الجديد الذي دشنه المسيح. فلنطلب من الله تلك الشجاعة. نريد أن ننتصر على العالم، حاملين على عاتقنا الصليب نفسه، الذي هو صليبنا أيضاً، المكون من الألم والمحبة، والحقيقة والخوف، والظلم والعطاء، والصراخ والمغفرة." (رسالة إلى الأبرشية بأسرها، نشرت في 24 تشرين الأول 2023)
في الختام، لا يمكن للغفران وحده أن يبني السلام. وبالمثل، لا يمكن للحقيقة والعدالة وحدهما أن تبنيا السلام. إن العلاقة بين هذه الكلمات معقدة وغالبًا ما تثير نقاشًا حادًا، ولكنها أيضًا تحث على التفكير العميق.
إن الحديث عن المغفرة فقط، بمعزل عن الحق والعدالة، في سياقنا المحدد، هو تجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. إنه تجاهل للكرامة الإنسانية، إلى جانب جميع الحقوق المتأصلة في تلك الكرامة. إن الحديث عن المغفرة دون الاعتراف بحق الشخص في حياة عادلة وكريمة، هو حرمان المرء من حق الله، ولا يبني السلام.
تواجه الحقيقة والعدالة، عندما يتم فصلهما عن التسامح، قيودًا مماثلة. إن التأكيد على الحاجة إلى الحقيقة والعدالة هو أمرٌ مقدس. ولكن، عندما ينفصلان عن الرغبة في الغفران والتغلب على الشر المرتكب، فإنهما يحاصران الخصم دون أن يقدما له مخرجًا. إنها تحولهم إلى متهمين، وتحمّلهم المسؤولية عن أفعالهم ولكنها تفشل في توفير وسيلة للحل. وبالتالي، قد يتحول الموقف إلى مجرد تبادل للاتهامات، مما قد يؤجج معارضة أكثر عدوانية.
لذلك، من الضروري للعناية الرعوية الكنسية أن تعرف كيف تدمج هذه العناصر الثلاثة في حوار مستمر وصعب ومؤلم ومعقد وممزق ومتعب. لكنها عملية مثمرة وتحترم حقوق الله والإنسان. إنها تبني شيئًا فشيئًا آفاق للسلام في أوقات خارجة عن سيطرتنا. إن ما يدعم هذه الأنماط الثلاثة للحياة والعلاقات فيما بيننا ليس الأيديولوجية، بل المحبة. "مَحَبَّةَ اللّه أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا." (رومة 5: 5). هذه المحبة هي التي تدفعنا إلى الرغبة في السلام. لا شيء آخر.
الخاتمة
في الختام، أعتقد أن خدمة السلام داخل الكنيسة هي في الأساس تجسيد لجوهر كوننا كنيسة. إنها تنطوي على البقاء صادقين مع أنفسنا، راسخين في ما يعضدنا، وأن نعيش ونعلن ونشهد لهذا دون خوف أو رياء.
وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أضيف تأملا قصيرًا. في الأرض المقدسة، نشهد بألم الأزمة المتصاعدة للمنظمات المتعددة الأطراف، كالأمم المتحدة، التي أصبحت عاجزة بشكل متزايد، وبالنسبة للكثيرين، مقيدة من قبل القوى العظمى (لاحظوا قوى الفيتو المختلفة). إن المجتمع الدولي يزداد ضعفًا، وكذلك مختلف المنظمات الدولية الأخرى.
وخلاصة القول، إن أولئك الذين تم انتدابهم على الصعيد الدولي للحفاظ على السلام وتعزيزه، والدفاع عن الحقوق، وبناء نماذج كريمة للمجتمع، أظهروا جميع نقاط ضعفهم. تواجه القيادة المحلية تحديات أكبر من مختلف الأنواع. وهو واقع مألوف لنا جميعًا للأسف.
ما ينقصنا، باختصار، هو مرجعيات سياسية واجتماعية قادرة على القيام بمبادرات في في المنطقة، وبناء الثقة، والقادرة على اتخاذ خيارات جريئة من أجل السلام، والتفاوض على المصالحات، وقبول المساومات الضرورية، وما إلى ذلك.
في هذا السياق المقفر، يجب على ولكهنة والعامليين في المجال الرعوي الكنيسة، توخي الحذر من الوقوع في تجربة سهلة: تجربة استبدال أنفسهم بهذه المنظمات، والانخراط في ديناميات المفاوضات السياسية التي تخضع بطبيعتها لتنازلات ليست سهلة أبدا، وغالبا ما تكون مؤلمة ومثيرة للجدل. إن إغراء ملء الفراغ الذي خلفته السياسة أمر سهل، كما أن طلب الكثيرين لسد ذلك الفراغ دائمًا ما يكون ملحًا.
لكن هذه ليست مهمة الكنيسة، التي، كما قلت، يجب أن تبقى كنيسة، جماعة إيمان، وهذا لا يعني الانفصال عن الواقع، بل أن تكون دائما على استعداد للانخراط مع أي شخص لبناء السلام، لتسهيل خلق سياقات تساعد في بناء آفاق سياسية، ولكن تبقى أصيلة لرسالة الكنيسة. دون الدخول في ديناميكيات سياسية لا تنتمي إليها، والتي غالبًا ما تكون بطبيعتها بعيدة عن لغة الإنجيل.
خدمة السلام ليس لها سوى الإنجيل كمرجع لها. فخصائص ومعايير بناء السلام جميعها متضمنة فيه. يجب أن نبدأ من هناك وأن نعود إليه باستمرار. وتكمن مساهمتنا في النسيج الاجتماعي لأبرشيتنا المضطربة في تعزيز الرغبة الصادقة والمخلصة والإيجابية والملموسة داخل المجتمع. والتصرف والالتزام بلقاء الآخر، ومعرفة كيفية المحبة على الرغم من كل شيء، والمساعدة في تفسير الألم في ضوء الإيمان، ومعرفة كيفية تحقيق الوحدة بين الإيمان والحياة. انطلاقًا من الإصغاء إلى كلمة الله التي هي المصدر الرئيسي لكل معيار لتفسير واقع حياتنا.