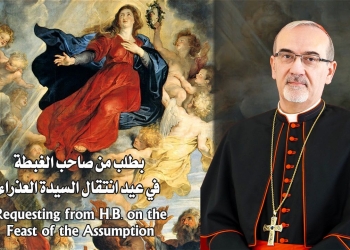يتحدّث إنجيل اليوم عن الله، وعن كيفيّة الوجود والعيش في حضرته، إنّه يكشف لنا وجه العدالة الإلهيّة، ويعلّمنا أنّ الله هو وحده الذي يبرّر، وهو الذي يصنع العدالة الحقّة، وعدالته ليست دينونة، بل غفرانٌ يعيد الإنسان إلى مقامه الأول، ويُجدّد العهد بين الله والبشر.
تدعونا الكلمة اليوم إلى الدخول في عمق الهيكل، إلى المكان الذي يُقرَّر فيه مصير الإنسان أمام الله، وهناك نسمع السؤال يهمس في قلوبنا: أيّ عدالة نطلب؟ وأيّ سلام نرغب فيه؟
ها نحن أمام مشهد الإنجيليّ: رجلان صعدا إلى الهيكل ليُصلّيا، رجلان، صلاتان، وقلبان. الأوّل يقف أمام الله بثقة المتكبّر الذي يرى نفسه بارًّا، والثاني بتواضع الخاطئ الذي يعرف أنّه لا شيء من دون رحمة الله.
الفريسي، رغم حفظه للشريعة، لا يدخل في علاقة حيّة مع الله، يرفع عينيه، لكن نظره لا يتوجّه إلى الله، بل إلى ذاته، يتكلّم فقط عن نفسه، يقارن نفسه بالآخرين ويحكم عليهم.
من الجدير بالذكر إن الإنجيل لم يصفه بأنّه مراءٍ، بل هو رجل متديّن بإخلاص، يعمل أكثر ممّا تطلبه الشريعة، لكنّ هذا الإخلاص تحوّل إلى سبب للغرور والرضى عن الذات، فصار ضميره مطمئنًا بطريقة زائفة، يظنّ أنّه أفضل من الآخرين.
أمّا العشّار، فكلّ اتّكاله على الله. يخفض نظره، لكنّ الله هو الذي يرفع عينيه نحوه. يعترف بخطيئته دون تبرير أو دفاع عن تصرفه.
لا يُخفي ضعفه، بل يقف امام الله كما هو، بلا أقنعة ولا حجج. لا يقارن نفسه بأحد، بل يصرخ ببساطة: «اللهمّ ارحمني أنا الخاطئ». وفي هذه الصرخة، يقف في حضرة الله بالحقّ، حقّ من يعرف أنّ الله وحده هو البارّ، وأنّ في برّه يحتضن كلّ إنسان، حتى الخاطئ.
لأنّ في الله، الرحمة والعدالة وجهان لوجه واحد: فأن تقيم العدالة يعني أن تغفر.
العشّار يعرف أنّه خاطئ، لكنه لا يخاف أن تكون خطيئته عائق للقائه بالرب، لا يخفيها، ولا يحاول تبريرها، لأنّه يملك فقط شقاءه. وهناك، في هذا العُري الصادق للنفس، يلتقيه الله ويبرّره.
أمّا موقف الفريسي، فهو للأسف أكثر انتشارًا ممّا نتصوّر في عالمنا. إنّه موقف من يثق بقوّته، أو بتفوّقه الأخلاقي، مقتنعًا بأنّه وحده على حقّ، من يمنح نفسه حقّ الحكم على الآخرين وتفسير تصرفاتهم كما يشاء: «أشكرك لأنّي لست مثل سائر الناس، السارقين، الظالمين، الزناة، ولا مثل هذا العشّار» (لوقا 18: 11).
وهذا الموقف لا يسكن القلوب فقط، بل قد يتسرّب أيضًا إلى المؤسّسات، حتّى الكنسيّة منها. فبدلًا من بناء علاقةٍ مع الله، ونسجِ روابطَ عادلةٍ مع الآخرين، يؤدّي هذا الموقفُ إلى إقامةِ حواجز، ويولِّدُ سوءَ الفهم، ويُغذّي العنف. وكم من الألم يولَد بسبب فكرةٍ شخصيّةٍ عن العدالة، حين تُفرَض بمعزلٍ عن الاحترامِ والإصغاءِ المتبادَل!
وفي هذا السياق، أفكّر في أرضنا المقدّسة، كراهية عميقة ومُمزِّقة اجتاحتنا، فخلقت انقسامات بين الشعوب وداخلها. آراء مختلفة ومشروعة تحوّلت إلى أحكام قاسية تجرح العلاقات وتُعمّق الجراح. وكثيرون اليوم، مثل الفريسي، نصبوا أنفسهم قضاةً على الآخرين، مقتنعين بأنّهم على صواب. لكنّ الإنجيل يذكّرنا أنّ الذي يبرّرنا ليس صواب أحكامنا، بل صدق قلوبنا أمام الله.
لقد ساد الوهم بأنّ القوّة شرط لبناء السلام، وأنّ السلاح وحده قادر أن يفرض حلاً عادلاً للنزاعات، وأنّ تحقيق العدالة يمرّ عبر القضاء على الخصم. لكنّنا رأينا ما أنتجته هذه القناعة من دمار مادّي وروحيّ وإنسانيّ. إنّ زمننا موسوم بالصراعات والجراح المفتوحة، وشعوبٍ تنظر إلى بعضها بالخوف والريبة. الجميع مقتنع بأنّه على حقّ، وأنّ ما يفعله مشروع، مُبرر، بل وضروري. وهكذا ندور في دائرة مغلقة يصعب كسرها.
نعم، هناك ألم حقيقيّ وعميق، يستحقّ الاحترام والإنصات، ولا يحقّ لأحد أن يستهين به.
لكنّنا نقف هنا لا لنحلّل الأوضاع سياسيًّا أو اجتماعيًّا، بل لنسمع ما يقوله لنا إنجيل الربّ في هذا اليوم المكرّس لشجاعة التجرّؤ على تحقيق السلام.
يُرينا يسوع من خلال الإنجيل طريقًا أخرى للوقوف أمام الله وأمام الإنسان: طريقًا لا تنبع من القوّة أو من تفوّق، بل من صدق القلب واتضاعه... وحدهم الذين يعترفون بضعفهم ويطلبون الرحمة، يمكنهم أن يصبحوا أدوات للمصالحة والسلام.
السلام الحقيقي يقوم على الإيمان والتوبة، على الوقوف أمام الله كما نحن، مثل العشّار، لا مثل الفريسي. فعندما نعترف بأنّنا لا شيء من دون الله، يصبح هو أساس وحدتنا. أمّا إذا بنينا العيش المشترك على أسس بشرية قائمة على القوّة والتفوّق، فإنّنا نبني على الرمل، بناءً سينهار عاجلاً أم آجلاً.
عندما يجعل الإنسان من نفسه سيّدًا على ذاته، ينتهي إلى هلاكه والمؤسّسات التي تشعر بالتفوق وتركز على خدمة مصالحها بدل أن تخدم جماعاتها، تزرع الدمار.
السلام لا يُبنى بالتصريحات، بل بقلوبٍ تسمح لأنفسها بأن يلمسها الله وواقع حياة الآخر، إنها تلك القلوب المنفتحة على الحقيقة، قادرة على الإصغاء والحوار، حتى حين يكون صعبًا، عندما نعترف بضعفنا نتيح لله مجال أن يعمل فينا، ومن يعترف بحاجته إلى الرحمة، يسمح أيضًا للآخرين بأن يرحموه والرحمة هي الأساس الذي تُبنى عليه كلّ عدالة، ومن ثمّ يمكن أن يُقام عليها سلامٌ ثابتٌ وصادق.
السلام ليس غياب الحرب، ولا مجرّد هدنة أو توازن قوى، بل هو رؤية وجه الله في وجه الإنسان الآخر. فعندما يتلاشى وجه الآخر، يتلاشى وجه الله من حياتنا، ومعه يختفي السلام الحقيقي. لا أحد يعيش وحده، فدمار وجه الآخر يعني تدمير وجه الذات.
لكي نبني السلام، علينا أن نتعلّم كيف نرى الآخر، وأن نسأل أنفسنا أيضًا كيف ننظر إليه، خصوصًا الفقير والمظلوم والمنسي. فهذه هي رسالة الكنيسة: أن تُبقي العالم متيقّظًا لوجود أولئك الذين يفضّل كثيرون تجاهلهم، ومع ذلك فهم موجودون، ينتظرون محبّةً تلتفت إليهم.
السلام هو ثمرة العدالة والرحمة والحقيقة. إنّه وجه الله المنعكس في وجوهنا حين نسمح لأنفسنا أن نتصالح معه ومع إخوتنا.
الرحمة، والعدالة، والحقيقة، والسلام — كلماتٌ محوريّة في حياة العالم، غير أنّها قد تبدو أحيانًا بعيدةً عن الواقع الملموس لكثيرٍ من الشعوب. إنّها كلماتٌ تتطلّب الكثير، وقد تُثير الانزعاج في بعض الأحيان، لا سيّما في الأرض المقدّسة – موطني – حيث تبدو، في نظر كثيرين، شعاراتٍ فارغةً أمام واقعٍ أنهكه صراعٌ طال أمده. ومع ذلك، فإنّ شهادة رجالٍ ونساءٍ شجعان — “العشّارين" في زمننا — أعادت لتلك الكلمات معناها الحقيقي والملموس، حتى وسط المآسي. إنّهم الذين يعرفون أن يقرعوا صدورهم (لوقا 18: 13)، ويعترفون بحاجتهم إلى الرحمة، فيصبحوا قادرين على منحها، على الانحناء أمام جراح الآخرين، وعلى رؤية وجه الله فيهم.
إنّهم الشباب الذين فقدوا عائلاتهم وما زالوا يمدّون أيديهم لمساعدة عائلات أُخرى منكوبة؛ والعائلات التي تشارك لقمتها القليلة مع من فقد كلّ شيء؛ والمعلّمون الذين بلا مدارس لا يتوقّفون عن البحث عن تلاميذهم؛ والأمّهات اللواتي يعتنين بالأطفال المتروكين؛ والأطباء والشباب الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل الجرحى والضعفاء. هؤلاء هم البذار الحيّة للرجاء وسط الركام.
نحن بحاجةٍ إلى هؤلاء الشهود، إلى الذين يُكرِّسون أنفسهم بتواضعٍ في خدمة الله والإنسان. وفي خضمّ الدمار الإنساني الذي عايشناه في الأشهر الأخيرة، التقينا بكثيرين منهم، فكانوا – وما زالوا – أدواتٍ لا غنى عنها للعزاء والرجاء لكثيرين. هم الذين سيُعيدون بناء جسور اللقاء من تحت أنقاض هذا الزمان.
لم يُفقد كلّ شيء بعد، فما زال هناك أبرار يعرفون كيف يصنعون عدالة الله، ويحملون الغفران والعزاء، ويعترفون بعضهم ببعض كإخوة وأخوات، كأبناء محبوبين لله، يلتزمون بحفظ صورته في العالم، طالما وُجد هؤلاء، ستبقى كلمات العدالة والمغفرة والحقيقة والسلام ممكنة، حتى في أرضنا المقدّسة.
فلنطلب اليوم من الربّ أن يمنحنا قلبًا جديدًا، قلبًا يعرف أن يبكي على ألم العالم، لا ينغلق في الخوف، بل ينفتح على الثقة. قلبًا، مثل قلب العشّار، يهمس بتواضع: «اللهمّ ارحمني أنا الخاطئ»، ويبدأ من جديد من هناك.
ونشكر جماعة سانت إيجيديو على التزامها الدؤوب في بناء جسور السلام حيثما يرفع العالم الجدران.
فالقلب المتصالح وحده قادر أن يصالح، والقلب المبرَّر وحده قادر أن يبرّر، والقلب المسالم وحده يجرؤ أن يصنع السلام.